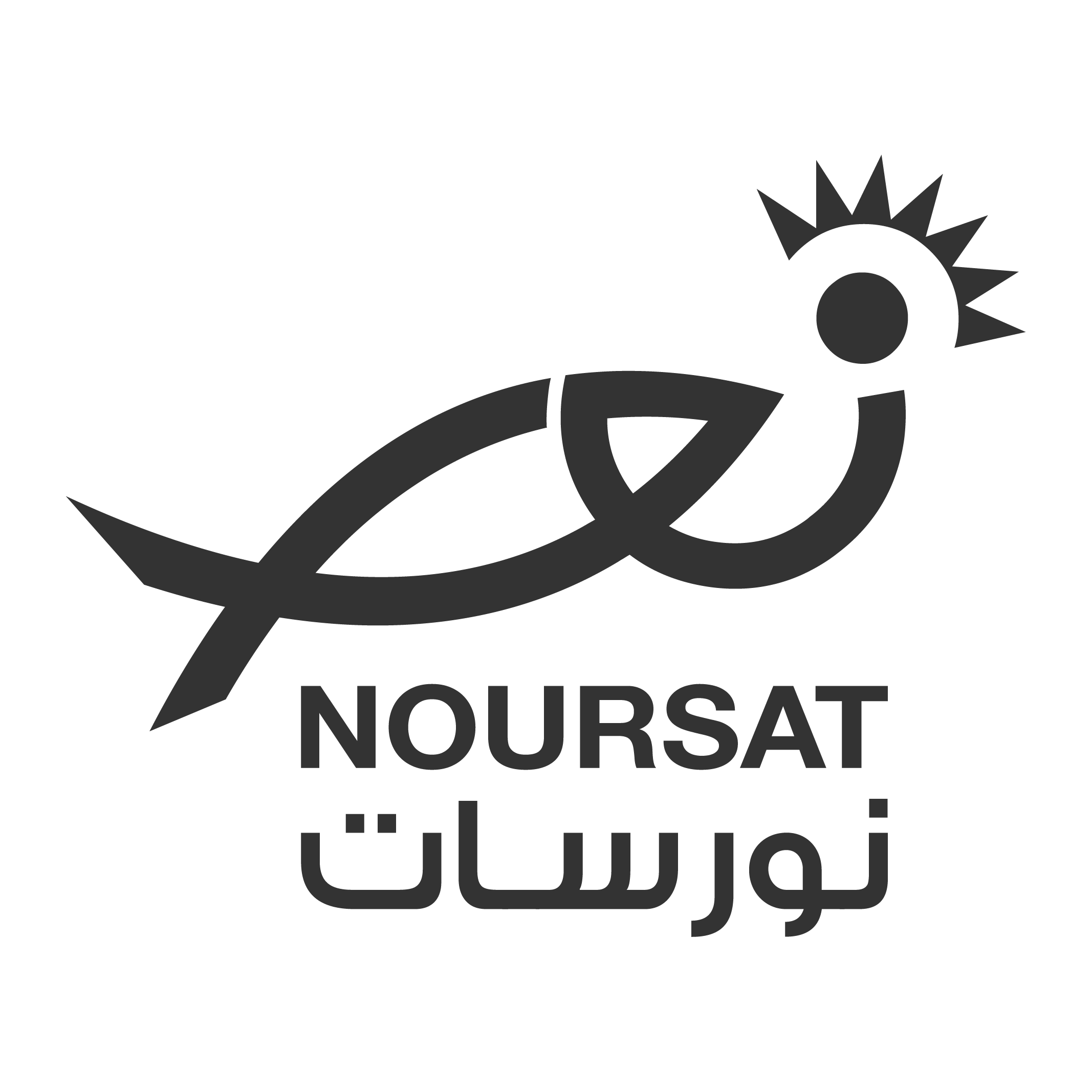ألقى واعظ القصر الرَّسوليّ الأب روبرتو بازوليني تأمّله الأوّل لزمن المجيء في قاعة بولس السّادس بالفاتيكان بحضور البابا فرنسيس، تحت عنوان: “باب الدّهشة”.
واستهلّ بازوليني تأمّله بالقول، بحسب “فاتيكان نيوز”: “خلال زمن المجيء، تجعلنا اللّيتورجيا نستمع إلى العديد من النّصوص النّبويّة الّتي تهدف إلى جعلنا نجد الدّهشة مجدّدًا إزاء سرّ التّجسّد: مجيء الرّبّ يسوع وعودته إلى العالم والتّاريخ. إنّها قراءات مليئة بالسّحر والرّجاء الشّجاع حيث يحاول الأنبياء، أشخاص اختارهم الله ودعاهم لكي يعطوا صوتًا لكلمته، أن يعيدوا إحياء الشّعب من خلال إشعال رؤى ووجهات نظر غير مسبوقة. ولكن من هم الأنبياء؟ في تاريخ الخلاص يظهر الأنبياء كشخصيّات حاسمة لأنّهم “وحدهم يعرفون كيف يقدّمون المفتاح لفهم معنى الأحداث البشريّة، في جوانبها الإيجابيّة وخاصّة في جوانبها المأساويّة”. الأنبياء هم أشخاص دعاهم الله ليلاحظوا ويعلنوا في أيّ اتّجاه يسير التّاريخ بحسب مخطّط الله ومشيئته. والأداة الّتي يمارس بها الأنبياء خدمتهم هي الكلمة. من ناحية، هذه الكلمة هي قويّة، لأنّها تنقل نظرة الله وحكمه على الواقع. ولكن كلمتهم من ناحية أخرى، هي أداة ضعيفة جدًّا، فهي لا يمكنها أن تفرض ولكنّها تقترح فكر الله فقط.
ليس هناك ما هو أضعف من الكلمة، إذ لها ثلاثة أوجه من الضّعف. إنّها ريح تهزُّ، محدودة المسافة، ومحصورة في حدود اللّغات، ذات أمد لحظيّ، وتخضع لاضطرابات لا حصر لها. هي ضعيفة أيضًا لأنّ الّذي يلفظها ضعيف، إذ ليس له ثروات تزكِّيه ولا جيوش تؤيّده، ولا محاكم تُقره. هي ضعيفة لأنّها موجّهة إلى القلوب البشريّة، المُخدَّرة أو المتعبة أو العنيدة أو الجبانة. هي ضعيفة لأنّ الّذين عليهم أن يتلفّظوا بها قد يهربون (مثل يونان) أو يصمتون (مثل إرميا)؛ لأنّ الّذين يجب أن يسمعوها قد يغلقون آذانهم أو يقسّون قلوبهم؛ لأنّه عندما يتمُّ التّلفُّظ تتوقّف عن الوجود. إنّ رسائل الأنبياء لا يمكن الإصغاء إليها بسطحيّة أو تلهّي. وقوّتها هي كبيرة لدرجة أنّها تستبعد أيّ إمكانيّة للّامبالاة: فالّذين يتلقّونها يجدون أنفسهم عند مفترق طرق، بين الانفتاح والقبول أو الانغلاق والرّفض. هذا الأمر كان يصلح بالنّسبة لإسرائيل في العصور القديمة ولا يزال يصلح بالنّسبة للكنيسة اليوم. ولكن لماذا يحدث هذا؟ لأنّ كلّ نبوءة نبويّة تهدف إلى تعزيز لقاء وحوار بين حريّتين: حرّيّة الله الأمين دومًا لعهده، وحرّيّة الإنسان الّذي غالبًا ما يكون متردّدًا وغير واثق من الإجابة على الدّعوة. ولكن ماذا يحدث للإنسان عندما يضع نفسه في الإصغاء إلى كلمة نبويّة؟ هناك آية من أحد المزامير توضح ذلك بشكل فعّال: “مرّة تكلّم الله ومرّتين سَمعت.”
تصف هذه الحكمة كيف يلمس صوت الأنبياء حساسيّتنا. عندما يتكلّمون، كأنّنا ندرك صوتين في آن واحد: صوت يعزّينا ويرفعنا، وصوت آخر يزعجنا ويوبّخنا. هذا التّناقض بالتّحديد هو الّذي يظهر في خبرة إرميا الّذي، عندما دُعي ليصبح نبيًّا في إسرائيل، استطاع أن يتغلّب على مقاومته الأوّليّة. شعر إرميا بالرّهبة من مهمّة التّحدّث إلى الشّعب، مدركًا أنّ على كلماته أن تُحدث تأثيرًا مزدوجًا: أن تهدم لكي تبني أيضًا. هذه هي بالضّبط المفارقة في كلّ صوت نبويّ، وهي واضحة في جميع صفحات الكتاب المقدّس العظيمة، من الأنبياء الكبار وصولًا إلى الأنبياء الصّغار. إنّ الصّعوبة الّتي نواجهها في الإصغاء إلى الكلمة النّبويّة تنبع من كثافتها التّواصليّة الّتي تهدف إلى إعادة تنشيط ديناميكيّة ارتدادنا إلى الله. في الواقع، تميل قلوبنا إلى الخوف والانغلاق عندما تواجهنا محفّزات شديدة. سيكون من السّذاجة أن نعتقد أنّ هذا الانغلاق يعتمد فقط على اللّهجة القاسية الّتي يهزّ بها الأنبياء ضمائرنا. في الواقع، نجد أنفسنا صُمًّا وغير راغبين في الإصغاء حتّى– وبشكل خاصّ- عندما يحاول صوت الله أن يُعيد فتح قنوات الرّجاء. إنّ قبول الأخبار السّارّة ليس أبدًا أمرًا فوريًّا، لاسيّما عندما يكون الواقع مطبوعًا منذ فترة طويلة بالألم وخيبة الأمل وعدم اليقين. غالبًا ما تتسلّل إلى قلوبنا تجربة الاعتقاد بأنّ لا شيء جديد يمكنه أن يحدث، وتغذِّي تشاؤمًا خفيًّا. ومع ذلك فإنّ صوت الأنبياء يبلغنا هنا، حيث نميل إلى الاعتقاد بأنّ الواقع لم يعد بإمكانه أن يقدّم لنا بصيصًا جديدًا من النّور، وأنّ الوعود الّتي حاولنا أن نؤمن بها لن تتحقّق أبدًا، وأنّ أفضل الأشياء في الحياة هي مجرّد ذكريات محفوظة في صندوق الذّكريات.
هذا هو التّحدّي الّذي يدعونا زمن المجيء لمواجهته: أن نتنبّه لحضور الله وعمله في التّاريخ وأن نوقظ دهشتنا لما لا يستطيع أن يحقّقه في حياتنا وفي تاريخ العالم فحسب، وإنّما وبشكل خاصّ لما زال يرغب في أن يحقّقه فيهما. خلال أكثر من ثلاثين سنة من حياته “الخفيّة” في النّاصرة، فهم يسوع هذا الرّجاء بعمق لدرجة أنّه عندما أعلن الإنجيل للعالم لأوّل مرّة اختار أن يبدأ بهذه الكلمات بالذّات: “تمّ الزّمان واقترب ملكوت الله. فتوبوا وآمنوا بالبشارة”. ولكي نعدّ أنفسنا للإصغاء إلى الأصوات النّبويّة الّتي ترشدنا في كلّ مجيء نحو الاحتفال بعيد الميلاد، وهذه السّنة أيضًا نحو بداية سنة اليوبيل المقدّسة، يمكننا أن نوجّه أنظارنا إلى شخصيّتين نسائيّتين: أليصابات ومريم العذراء. في خبرتهما الإنسانيّة والرّوحيّة يتكثّف الموقفان الأساسيّان اللّذان يسمحان للكلمة النّبويّة أن تولِّد فينا ديناميكيّة خلاص حقيقيّة.
بحسب التّسلسل الزّمنيّ للأحداث الّذي رتّبه الإنجيلي لوقا بعناية، فإنّ دخول أليصابات إلى المشهد يمهّد له إعلان ولادة يوحنّا المعمدان الموجّه إلى زوجها زكريّا بينما كان يقوم بخدمته الكهنوتيّة في الهيكل في أورشليم. تَراءَى لَه مَلاكُ الرَّبِّ قائِمًا عن يَمينِ مَذبَحِ البَخُور. فَاضطَرَبَ زَكَرِيَّا حينَ رآهُ واستَولى علَيِهِ الخَوف. فقالَ لهَ الـمَلاك: “لا تَخَفْ، يا زَكَرِيَّا، فقدَ سُمِعَ دُعاؤُكَ وسَتَلِدُ لكَ امَرأَتُكَ أَلِيصاباتُ ابنًا فَسَمِّه يوحَنَّا. وستَلْقى فَرَحًا وابتِهاجًا، ويَفرَحُ بِمَولِدِه أُناسٌ كثيرون. لِأَنَّه سيَكونُ عَظيمًا أَمامَ الرَّبّ، ولَن يَشرَبَ خَمرًا ولا مُسكِرًا، ويَمتَلِئُ مِنَ الرُّوحِ القُدُس وهوَ في بَطْنِ أُمِّه، ويَرُدُّ كَثيرًا مِن بَني إِسرائيلَ إِلى الرَّبِّ إلهِهِم ويَسيرُ أَمامَه وفيهِ رُوحُ إيليَّا وَقُوَّتُه، لِيَعطِفَ بِقُلوبِ الآباءِ على الأَبناء، ويَهْديَ العُصاةَ إلى حِكمَةِ الأَبرار، فَيُعِدَّ لِلرَّبِّ شَعبًا مُتأَهِّبًا”. فَقالَ زَكرِيَّا لِلـمَلاك: “بِمَ أَعرِفُ هذا وأَنا شَيخٌ كَبير، وَامرَأَتي طاعِنَةٌ في السِّنّ؟”. فَأَجابَهُ الـمَلاك: “أَنا جِبرائيلُ القائِمُ لدى الله، أُرسِلتُ إليكَ لأُكلِّمَكَ وأُبَشِّرَكَ بِهذه الأُمور وسَتَظَلُّ صامِتًا، فلا تَستَطيعُ الكلامَ إلى يَومَ يَحدُثُ ذلك، لأَنَّكَ لم تُؤمِنْ بِأَقوالي وهي سَتَتِمُّ في أَوانِها”. قد يبدو سؤال الكاهن المسنّ مشروعًا تمامًا، بل يكاد يكون حتميًّا. إنّ الشّكّ مفهوم: كيف يمكن لزوجين مسنّين الآن أن يلدا طفلاً؟ ومع ذلك، فإنّ جواب رئيس الملائكة جبرائيل واضح وفوريّ: في رغبته في “أن يعرف”، أيّ “أن يفهم”، هذا الاقتراح الّذي يبدو مستحيلًا من الله، كشف زكريّا أنّ قلبه حائر ولا يستطيع أن يؤمن. وبسبب عدم الإيمان هذا، سيبقى أبكم ولن يستطيع أن يتكلّم قبل يوم معيّن لن يتزامن مع ولادة يوحنّا، بل مع لحظة ختانه، بحسب ما تنصّ عليه الشّريعة.
“وجَاؤُوا في اليَومِ الثَّامِنِ لِيَخِتنوا الطِّفْلَ وأَرادوا أَن يُسَمُّوُه زَكَرِيَّا بِاسمِ أَبيه”. مع أنّ زكريّا كان يعلم أنّ اسم الطّفل لن يكون اسمه هو، بل “يوحنّا”، إلّا أنّ الجيران والأقارب الّذين توافدوا إلى الحفل أصرّوا على اتّباع التّقاليد، واقترحوا أن يسمّوه باسم أبيه. ولكن تدخّلت أمّه قائلة: “لا، بل يُسَمَّى يوحَنَّا”. لم يكن الفرق في المعنى بين الاسمين كبيرًا، فزكريّا يعني “الله يتذكّر”، بينما يوحنّا يعني “الله يرحم”. كلا الاسمين يستحضران حضور الله في التّاريخ البشريّ، وإن كان بلهجات مختلفة. يتطلّع اسم زكريّا إلى الماضي، مذكّرًا بالخلاص الّذي بناه الله على مرّ الزّمن: تدخّلاته، عجائبه، أمانته. أمّا يوحنّا، من جهة أخرى، فينقل التّركيز إلى اليوم، مشدّدًا على ما ينوي الرّبّ أن يُتمِّمه في الحاضر في ضوء مستقبل مليء بالرّجاء. بهذا المعنى، يصبح اسم يوحنّا نبوءة تجديد. لقد فاجأ ردّ فعل أليصابات الحاضرين، لأنّه قدّم معيارًا غير مألوف، ويخرج عن المألوف ويشير إلى أنّه من الضّروريّ أحيانًا أن نقطع مع الاستمراريّة لكي ننفتح على تجديد الله. لم يكن “احتجاج” أليصابات اللّطيف كافيًا لتغيير الرّأي السّائد: بل كان هناك انتظار تأكيد وإشارة من الأب زكريّا. وبالتّالي أصبح لدى الكاهن المسنّ فرصة ثانية لكي يؤمن بإعلان الله، وهذه المرّة لم يتردّد في تصديق إعلان الله: هذا الطّفل سيدعى باسم جديد نطق به فم الرّبّ. فثارت دهشة كبيرة بين جميع الضّيوف، وانطلق لسان زكريّا وانفتح فمه وبارك الله. لقد فهم أليصابات وزكريّا، بعد ألم ومسيرة شخصيّة طويلة، أنّ الله لم يكن أمينًا لقصّتهما فحسب، بل كان يُعدُّ فيها مفاجأة جديدة عظيمة.
لذلك فبينما نعتقد أنّ الحياة مطبوعة بشكل جذريّ بشروطها الأوّليّة (الأبويّة)، يعلن الإنجيل أنّه بين المقدّمات وتطوّر الحياة البشريّة هناك أيضًا– وبشكل خاصّ- انقطاع، وحضور معيّن لله ينتزع اسم الإنسان من أيّ قدر مكتوب مسبقًا ومن أيّ قدريّة. واليوم أكثر من أيّ وقت مضى نحن نحتاج إلى استعادة هذا النّوع من النّظرة الرّوحيّة إلى الواقع. إنّ الـ”لا” الّتي قالتها أليصابات والّتي تضع مصير يوحنّا بين يدي الله تذكّرنا بأنّ لا شيء ولا أحد مشروط بتاريخه وجذوره فقط، بل هو مشروط أيضًا بنعمة الله. وبالتّالي فكلّ قصّة بشريّة، بأنوارها وظلالها، ليست ثابتة أبدًا في كتاب كُتب مُسبقًا، بعدد صفحات محدّد مسبقًا. وإنّما بالانفتاح على الإصغاء لكلمة الله وبتعلّم التّعرُّف على عمله وعنايته، يمكننا أن نكتشف أنّ الأفضل لم يأتِ بعد، وأنّ الأيّام الأجمل ما زالت أمامنا وأنّ مغامرة الحياة قد بدأت للتّوّ. إذا كنّا قد رأينا في أليصابات كيف أنّه من الضّروريّ أن نعرف كيف نقول “لا” للاستمراريّة الظّاهرة للأشياء والعلاقات، يمكننا أن نرى في مريم، ابنة النّاصرة، ضرورة أن نعرف كيف نقول “نعم” لحداثة الله، وأن نصوغ موافقة حُرَّة وفرِحَة لمشيئته.
“وفي الشَّهرِ السَّادِس، أَرسَلَ اللهُ الـمَلاكَ جِبرائيلَ إِلى مَدينَةٍ في الجَليلِ اسْمُها النَّاصِرَة، إِلى عَذْراءَ مَخْطوبَةٍ لِرَجُلٍ مِن بَيتِ داودَ اسمُهُ يوسُف، وَاسمُ العَذْراءِ مَريَم. فدَخَلَ إلَيها فَقال: “إفَرحي، أَيَّتُها الـمُمتَلِئَةُ نِعْمَةً، الرَّبُّ مَعَكِ”. يصف الإنجيل مريم بأنّها عذراء. وهذه الصّفة لا تُستخدم فقط لتحديد حالتها البيولوجيّة، وإنّما أيضًا موقفها الدّاخليّ. وفي وصف اللّقاء السّرّيّ الّذي تمَّ في البشارة، يصف الإنجيليّ اقتراب الملاك من مريم بأنّه “دخل إليها”. إذن، لا يبدو أنّ مهمّة الملاك هي مجرّد الدّخول إلى مكان مادّيّ، بل الدّخول إلى قلب مريم، بدون أن يقتحم بأيّ شكل من الأشكال أبواب جهوزيّتها. إنَّ الكلمة لا تحتاج إلى شيء آخر: أن تعبر أبواب جهوزيّتنا وتبلُغَنا إلى ذلك المكان الّذي يمكن أن يتطوّر فيه الحوار مع الله في حرّيّة متبادلة. ربّما تكون هذه المرحلة من الحياة الدّاخليّة من أكثر المراحل حساسيّة في حياتنا المسيحيّة كلّها. إنّ دخول كلمة الله إلينا هو حدث عجيب ولكنّه مؤلم أيضًا، لأنّه يشبه اللّحظة الّتي تخترق فيها إبرة أو شفرة جلدنا مسبّبةً لنا الانزعاج والألم. “إِنَّ كَلامَ اللهِ حَيٌّ ناجع، أَمْضى مِن كُلِّ سَيفٍ ذي حَدَّين، يَنفُذُ إِلى ما بَينَ النَّفْسِ والرُّوحِ، وما بَينَ الأَوصالِ والمِخاخ، وبِوُسْعِه أَن يَحكُمَ على خَواطِرِ القَلْبِ وأَفكارِه، وما مِن خَلقٍ يَخْفى علَيه، بل كُلُّ شيَءٍ عارٍ مَكْشوفٌ لِعَينَيه، ولَه يَجِبُ علَينا أَن نُؤَدِّيَ الحِساب”.
إنّ كلمة الله تعمل فينا كالسّيف الحادّ الثّاقب، القادر على الوصول إلينا في النّفس، في مركز ذواتنا، هناك حيث تقف كلّ مفاصل حياتنا في توازن هشّ. هذا المكان الحميم، والّذي غالبًا ما يكون غريبًا حتّى عن ضميرنا، هو بالتّحديد قلبنا، حيث تظهر هويّتنا في عيني الله عارية ومعروفة بشكل كامل. نحن نخاف من هذا اللّقاء لأنّنا نعلم أنّ نظرة الله يمكنها أن تهدم فجأة كلّ يقين وتجعلنا نفقد السّيطرة على حياتنا. في الوقت عينه، نحن نرغب بشدّة في هذا اللّقاء لأنّنا نعلم جيّدًا أنّنا في نظر الله فقط سنتمكّن أخيرًا من التّعرّف على أنفسنا في نور جديد، نور الحبّ العظيم القادر على تجديد كلّ شيء. لقد قبلت مريم كلمة الرّبّ وسمحت لصوته أن يعلن لها حداثة مدهشة: “إفَرحي، أَيَّتُها الـمُمتَلِئَةُ نِعْمَةً، الرَّبُّ مَعَكِ”. فداخَلَها لِهذا الكَلامِ اضطرابٌ شَديدٌ وسأَلَت نَفسَها ما مَعنى هذا السَّلام. لقد وجّه الملاك إلى مريم أمرًا جميلاً بقدر ما هو متناقض. إذا كان الفرح هو الحالة الّتي نرغب جميعًا في أن نعيشها قدر الإمكان، فمن الصّحيح أيضًا أنّه شعور يصعب علينا أن نرتجله عندما نفتقده. والعكس صحيح، إذا كان قلبنا يفيض بالفرح، فلا يمكننا ألّا نُظهر ذلك إلى الخارج.
أمام هذا الخبر، دخلت مريم في اضطراب شديد. يقول الإنجيليّ بأنّها اضطربت، مثل قارب يهتزّ ويضطرب بموجة عارمة مفاجئة. لماذا؟ لسببين على الأقلّ. الأوّل هو أنّه عندما يُظهر لنا شخص ما محبّته لنا، يكون ذلك دائمًا مفاجأة. لأنَّ الحبّ ليس أمرًا مفروغًا منه، بل هو حالة جديدة في كلّ مرّة يحدث فيها. واليقين في أنّنا محبوبين لا يُكتسب مرّة واحدة وإلى الأبد. أمّا السّبب الثّاني الّذي يجعل مريم تشعر بالخوف أمام الصّوت الملائكيّ فهو أن قلبها يشعر بأنّ الوقت قد حان لكي تسمح لصوت الله بأن يعيد تحديدها. عندما تصلنا دعوة عظيمة، دعوة تملأنا بالكرامة، ندخل في اضطراب سليم لأنّ حرّيّتنا تحتاج لأنّ تتحقّق وربّما أن تتأكّد من صحّة ما يتمّ تأكيده عنّا وعن حياتنا.
فقالَ لها الـمَلاك: “لا تخافي يا مَريَم، فقد نِلتِ حُظوَةً عِندَ الله”. لقد دُعيت مريم لكي تتخطّى الخوف الّذي تعيشه، لأنّ ما يريد الله أن يقترحه عليها هو في الواقع شيء متوافق جدًّا مع النّعمة الّتي كان قلبها ينشدها. “َستحمِلينَ وتَلِدينَ ابنًا فسَمِّيهِ يَسوع. سَيكونُ عَظيمًا وَابنَ العَلِيِّ يُدعى، وَيُوليه الرَّبُّ الإِلهُ عَرشَ أَبيه داود، ويَملِكُ على بَيتِ يَعقوبَ أَبَدَ الدَّهر، وَلَن يَكونَ لِمُلكِه نِهاية”. تبدو المهمّة كبيرة حقًا: الخطر بألّا يفهمها أحد، لا بل بأن يحكم عليها الجميع (كزانية) وهو خطر كبير جدًّا ومحتمل بحسب ما تنصّ عليه شريعة موسى. فَقالَت مَريَمُ لِلمَلاك: ” كَيفَ يَكونُ هذا وَلا أَعرِفُ رَجُلاً؟”. إنَّ هذا السّؤال يختلف تمامًا عن السّؤال الّذي جعل زكريّا أبكمًا. لأنَّ العذراء لا تريد أن تفهم مخطط الله بالتّفصيل، بل تريد ببساطة أن تشارك فيه بحرّيّة ووعي. ولهذا تطرح سؤالاً، وتقوم بما يشير بشكل لا لبس فيه إلى شغفنا بمقترح يتمّ إبلاغنا به. فأَجابَها الـمَلاك: “إِنَّ الرُّوحَ القُدُسَ سَينزِلُ عَليكِ وقُدرَةَ العَلِيِّ تُظَلِّلَكِ، لِذلِكَ يَكونُ الـمَولودُ قُدُّوسًا وَابنَ اللهِ يُدعى”. لم يشرح الملاك للعذراء كيف ستلد جسد ابن الله. بل قال لها فقط إنّ الرّوح القدس سيكون حارسها الأمين طوال مدّة الرّحلة، كما تفعل السّحابة عندما تحجب من فوق ما على الأرض. شعرت العذراء أنّ الفرح يغمر قلبها ليس فقط لهذا المشروع العجيب، وإنّما لأن كان هناك قوّة فائقة وأمينة تظلّلها وهي قوّة الله. وإزاء اقتراح الله المستحيل، لم تعد مريم بحاجة لأن تطلب أيّ شيء. إنّ التّصميم الّذي رسمته كلمة الملاك كان جذّابًا ومقلقًا، ومخيفًا ورائعًا في الوقت عينه. فَقالَت مَريَم: “أَنا أَمَةُ الرَّبّ فَليَكُنْ لي بِحَسَبِ قَوْلِكَ”.
إذ اكتشفت بأنّها مفيدة لله ولخلاص العالم، قرّرت مريم أن تودِّع الرّسول السّماويّ من خلال فعل بصيغة المفعول به “فليكن لي”. بهذه الطّريقة تعلن مريم كلّ حماسها للدّعوة الّتي نالتها. فهي لم تُحنِ رأسها في موقف التّواضع المتأثّر الّذي غالبًا ما نتقبّل به الأمور متظاهرين بالاقتناع والرّضا. بل هي تقول للملاك: “ما اقترحتَ عليَّ أن أقبله، في الواقع، أنا الآن أنا الّتي تريده وتختاره”. هكذا يتفاعل القلب الطّاهر، الممتلئ بالدّهشة، عندما يسمع كلمة الله ويقبلها، فيصرخ: “بالطّبع”. إنَّ مريم لم تسمح بأن يتمَّ توسُّلها أو أن يتمَّ إجبارها، ولكنّها تبّنت بفرح ما اقترحه عليها الملاك أن تؤمن به. وهكذا انتزعت من الله الابتسامة الأخيرة، وأعلمته أنّها لم تعد مبادرة السّماء وحدها هي الّتي تجمع بين البشريّ والإلهيّ. وإنّما الأرض أيضًا ترغب الآن في مصير الشّركة نفسه. إنَّ كلّ الإعلانات الّتي نتلقّاها في رحلة الحياة لا يمكنها أن تنتهي إلّا بهذه الطّريقة. عندما ينجح نور الله في أن يُظهر لنا أنّه في داخل الخوف ممّا ينتظرنا هناك أمانة الوعد الأبديّ، يولد فينا العجب ونكتشف بأنّنا قادرين على أن نعلن أخيرًا “هأنذا”.
لكي ننطلق نحو عيد ميلاد الرّبّ ونعبر باب اليوبيل برجاء حيّ، فإنّ أوّل حركة للقلب الّتي يجب علينا أن نوقظها تستيقظ هي الهشّة. ولكن لا يكفي أن نصغي إلى الكلمات الصّالحة والصّادقة والواعدة الّتي يخاطبنا بها الله باستمرار. علينا أوّلاً أن نخفّف من قساوة القلب، وأن نقول “لا” لكلّ ما يهدّد بأن يُغلقنا ويثقلنا: الخوف، الاستسلام، والتّهكُّم. بهذه الطّريقة فقط يمكننا أن ننفتح على حداثة الله، فنقبل فينا بذرة إرادته الصّالحة للجميع. إذا سمحنا للدّهشة بأن تجدّد قلوبنا، سنعرف كيف ننظر إلى كلّ شيء بعيون جديدة، ونتعرّف على بذور الإنجيل الحاضرة في الواقع، والمستعدّة لكي تُنبت وتحمل ثمار الله إلى العالم.”
- البابا لممثّلي التّقاليد الدّينيّة الأخرى: إذا توافقنا وتحرّرنا يمكننا أن نُسهم بفعاليّة في قول “لا” للحرب و”نعم” للسّلام
- هكذا تحيي رعيّة القدّيسة ريتا- سنّ الفيل عيد شفيعتها!
- الشّباب المارونيّ في كندا اجتمع في مونتريال للعودة إلى الجذور
- عبد السّاتر احتفل بقدّاس عيد دو لاسال في مدرسته بحضور خرّيجها الرّئيس عون
- يونان صلّى أمام ضريح البابا فرنسيس في روما
- ماذا قال البابا في كلمته بعد قدّاس بداية حبريّته وقبيل صلاة “إفرحي يا ملكة السّماء”؟
- رؤساء الكنائس الأرثوذكسيّة الشّرقيّة اجتمعوا في مصر وأصدروا بيانًا مشتركًا، والتّفاصيل؟
- عرس كنسيّ في زحلة: تدشين كنيسة وافتتاح متحف!
- عوده: كلمات يسوع يرفضها كلّ من يريد سلطة أمّا من يبتغي خلاص نفسه فيطلب الماء الحيّ
- البابا تسلّم درع التّثبيت وخاتم الصّيّاد في قداس بداية حبريّته
6 يونيو 2025