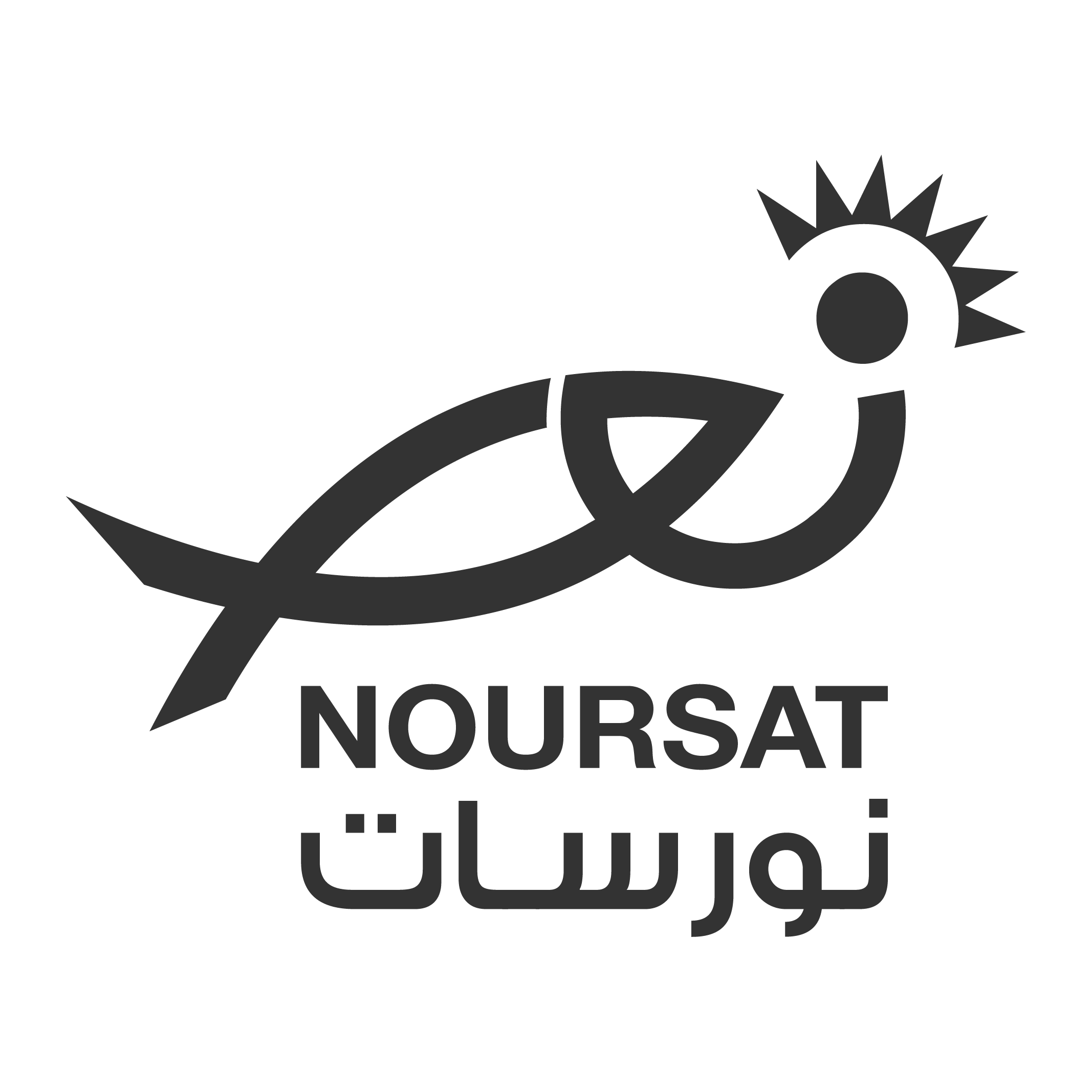جدّد متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس الياس عوده دعوته إلى السّلام والاستقرار والازدهار، إذ أنّه “آن أوان الجدّ والعمل، وكلّ تأخير سيدفع ثمنه الجميع”، وذلك في عظته خلال قدّاس الأحد في مار جاورجيوس- بيروت.
وكان عوده قد استهلّ عظته بتأمّل بإنجيل الأحد، فقال: “أحبّائي، في هذا الأحد نعيّد لمن تسمّيهم كنيستنا أجداد الرّبّ يسوع الّذين خدموا الله بأمانة، أو صنعوا عجائب بقدرة الله، أو أتى المسيح منهم بالجسد. وقد سمعنا اليوم مقطعًا إنجيليًّا يهزّ ضمائرنا ونفوسنا دومًا، وخصوصًا في مسيرتنا الصّياميّة نحو ميلاد المخلّص، الّتي شارفت على نهايتها.
سمعنا في الإنجيل أنّ إنسانًا صنع عشاءً ودعا إليه أصدقاءه ومعارفه ليتشاركوا الفرح، إلّا أنّ المدعوّين بدأوا يعتذرون لأسباب واهية وعلل متعدّدة. فالأوّل أراد أن يتفقّد حقله الّذي اشتراه، والثّاني شاء تجربة فدادين البقر الّتي ابتاعها، والثّالث اعتذر بداعي الزّواج، وكان بإمكانه إحضار زوجته معه إلى العشاء.
إذا تأمّلنا في هذا النّصّ، ونظرنا إلى حياتنا الرّوحيّة وطريقة تعاملنا مع الرّبّ والكنيسة، نجد أنّنا لا نختلف عن هؤلاء الأشخاص بشيء. فنحن كثيرًا ما نتوسّل أعذارًا واهيةً كي لا نذهب إلى الكنيسة ونشارك في عشاء الرّبّ، مع أنّ هذا اللّقاء السّرّيّ مع إلهنا هو اجتماع محبّة وسلام، وليس اجتماع عمل وقلق وتعب، وهو القائل لنا: “تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثّقيليّ الأحمال وأنا أريحكم” (مت 11: 28). كثيرًا ما نضع أيضًا العوائق أمام عيش مسيحيّتنا بتمامها، فلا نصوم ولا نصلّي ولا نقوم بأعمال المحبّة والخير، متذرّعين أنّ صحّتنا لا تحتمل صيامًا، مع أنّ الصّوم صحّيّ أكثر من الأكل على المستوى الجسديّ، فكم بالحريّ هو مفيد لصحّة النّفس؟ نقول أيضًا إنّ لا وقت لدينا كي نصلّي، فتقف حدود صلواتنا عند رسم إشارة الصّليب، الّتي رغم أهمّيّتها وضرورة إتمامها بالشّكل الصّحيح، إلّا أنّها لا تكفي. هل يكتفي العاشق بتذكّر حبيبه من دون اللّجوء إلى التّحدّث إليه ومشاركة همومه معه؟ الحال نفسها مع الرّبّ. صلاتنا إليه وحديثنا معه مهمّان جدًّا، أكانا بشكل فرديّ أو جماعيّ، لأنّ هذا الأمر يوطّد العلاقة بين الخالق والمخلوق، فندرك أكثر أنّ لنا إلهًا يحبّنا ويسمعنا ويبلسم جراحنا ويحلّ مشاكلنا، إذا اتّجهنا إليه بحرّيّتنا الشّخصيّة. إلّا أنّ هذا لا يكفي أيضًا، لأنّ الإيمان والصّلاة لا يمكن قياسهما، لذلك وجب أن ترافقهما أفعال حسّيّة تدلّ عليهما. أعمال المحبّة والرّحمة الّتي نقوم بها تجاه الآخر، مهما كانت بسيطةً، تدلّ على مدى عمق إيماننا وصلتنا بالرّبّ، لذلك يجب ألاّ نتذرع بأنّنا لا نستطيع تغيير شيء، كأفراد، ويجب أن نعمل كجماعة لتحقيق الأهداف. علينا فقط الشّروع بالعمل، والرّبّ يرافقنا، فنكون منارات تهدي الجميع بنورها وتدفعهم إلى القيام بالمثل، فيشعّ نور المسيح في الكون. أليس من أجل هذا القصد تجسّد الإله وصار طفلًا؟
بعدما اعتذر المدعوّون عن العشاء المعدّ على شرفهم، ما كان من صاحب الدّعوة إلّا أن أرسل يدعو المرذولين من المجتمع ليدخلوا ويفرحوا معه. قال لعبده: “أخرج سريعًا إلى شوارع المدينة وأزقّتها وأدخل المساكين والجدع والعميان والعرج إلى ههنا”. هكذا نحن، الّذين ندعو أنفسنا مسيحيّين، عندما لا نلبّي دعوة ربّنا إلى عشائه وفرحه، فإنّه لا يلغي الفرح، بل يكمل بسوانا، لأنّ الرّبّ خلق غيرنا والدّعوة لا تقف حدودها عندنا نحن. لقد ظنّ الشّعب العبرانيّ أنّه شعب الله المختار، إلى أن أفهمه الله أنّه خالق جميع الأمم، وأنّ للرّبّ الأرض وكلّ ما فيها، المسكونة وجميع ساكنيها كما نقرأ في سفر المزامير (مز 24: 1). الرّبّ نفسه يقول لنا: “إنّ العشّارين والزّواني يسبقونكم إلى ملكوت الله” (مت 21: 31)، فلا نظنّ أنّنا مختارو الله فقط لأنّنا ندعى “مسيحيّين”، وأنّنا نستطيع الإبطاء في تلبية الدّعوة أو التّملّص منها، ثمّ نلقي اللّوم على الرّبّ لأنّه لا يسمعنا ولا يساعدنا. عندما نفضّل المادّيّات الزّائلات على الرّبّ نكون قد اخترنا بملء حرّيّتنا أن نبتعد عنه، لأنّه هو لا يبتعد أبدًا عن خليقته، لكنّ “المدعوّين كثيرون والمختارين قليلون” كما قال الرّبّ في إنجيل اليوم. هل هذا البعد عن الله يفسّر المآسي والصّعوبات والحروب الّتي يعيشها الإنسان منذ بدء الخليقة؟ هل بعد الإنسان عن خالقه هو سبب الفراغ القاتل الّذي يعيشه البعض فيلجأون إلى وسائل قد تزيدهم تخبّطًا وفراغًا وبعدًا عن الله؟
فلنتعلّم من إنجيل اليوم أن نسرع في تلبية دعوة الرّبّ إلى عشائه وفرحه، مبتعدين عن أيّ حجّة أو سبب يمنعاننا من ذلك، وإلّا ستكون العاقبة أن نبقى خارج العرس، نقرع ولا يفتح لنا. فلنستعدّ جيّدًا، نفسًا وجسدًا، لاستقبال ملك الكلّ مولودًا في بيت لحم، ولنعمل بوصاياه حتّى نصل معه إلى الفصح السّرمديّ والفرح الأبديّ الّذي لا يزول.
هذه الحال تنطبق على علاقتنا بالوطن. إهمال قضيّة الوطن والتّمهّل في تلبية نداء الواجب بحجّة أعذار واهية يرميان صاحبهما في النّسيان ويدفعانه خارج المعادلة، ويستبدل بآخر، لأنّ التّاريخ يحاسب إن تلكّأ المواطنون، ولا بدّ للعدالة أن تنتصر.
يا أحبّة، القيام بالعمل المناسب في الوقت المناسب، وعدم إضاعة الوقت والفرص، أساس النّجاح. الإنسان النّاجح يقوم بعمله في أوانه، وأيّ عمل، مهما كان عظيمًا، يفقد معناه أو أثره إن حصل في غير وقته. هذا ينطبق على حياتنا الرّوحيّة وعلى الحياة الزّمنيّة أيضًا. فإن قام إنسان بتأجيل عمليّة جراحيّة مثلاً قد يموت. وإن تأخّر في إطعام طفله قد يؤذيه. وفي حياة الأوطان وتطوّرها، القيام بالأعمال في أوقاتها يساهم في تقدّمها ونموّها. هذا ما علينا إدراكه في لبنان حيث اعتدنا على تأجيل أمور أساسيّة كملء الشّواغر في المراكز القضائيّة والماليّة والعسكريّة والإداريّة، أو تأجيل الاستحقاقات من انتخابات نيابيّة أو بلديّة، وغيرها، ما انعكس سلبًا على حياة الوطن والمواطن. لكنّ الأخطر ما أصبح عادةً، وهو تأخير انتخاب الرّئيس، ما أعاق عمل كلّ المؤسّسات وساهم في تراجع البلد وتغييبه. لذا أملنا أن يعي المسؤولون عندنا أهمّيّة وجود رئيس في هذه المرحلة الدّقيقة من عمر بلدنا وأن يتمّ انتخاب رئيس في أسرع وقت، فيتسلّم زمام الأمور ويعمل مع حكومته على إعادة بناء الدّولة واستعادة هيبتها ودورها، وعلى حماية لبنان وإبعاده عن كلّ ما قد يشكّل خطرًا عليه وعلى بنيه. يكفي هذا البلد ما قاساه طيلة العقود الأخيرة، ويكفي الشّعب ما عاناه، وقد حان الوقت لكي ينعم بالسّلام والاستقرار والازدهار. آن أوان الجدّ والعمل، وكلّ تأخير سيدفع ثمنه الجميع.
لقد مرّت منذ يومين الذّكرى التّاسعة عشرة لإغتيال جبران تويني المناضل من أجل وطن الحرّيّة فيه مصانة، والعدالة سيّدة، والكلمة فاعلة. جبران نادى بالحرّيّة للجميع. حلم بمستقبل واعد لبلده. حارب الظّلم والاستعباد ووقف في وجه الطّغاة إلى أن أزالوه. لكنّ صوته ما زال يرنّ في الآذان، وكلماته تتردّد في الضّمائر الحيّة، فيما الطّغاة فرّوا، وتماثيلهم هوت، وسجونهم فتحت ولعنة شعوبهم ستلاحقهم إلى الأبد. وحده الحقّ يدوم. فهل من يعتبر؟
حمى إلهنا لبنان وشعبه، آمين.”