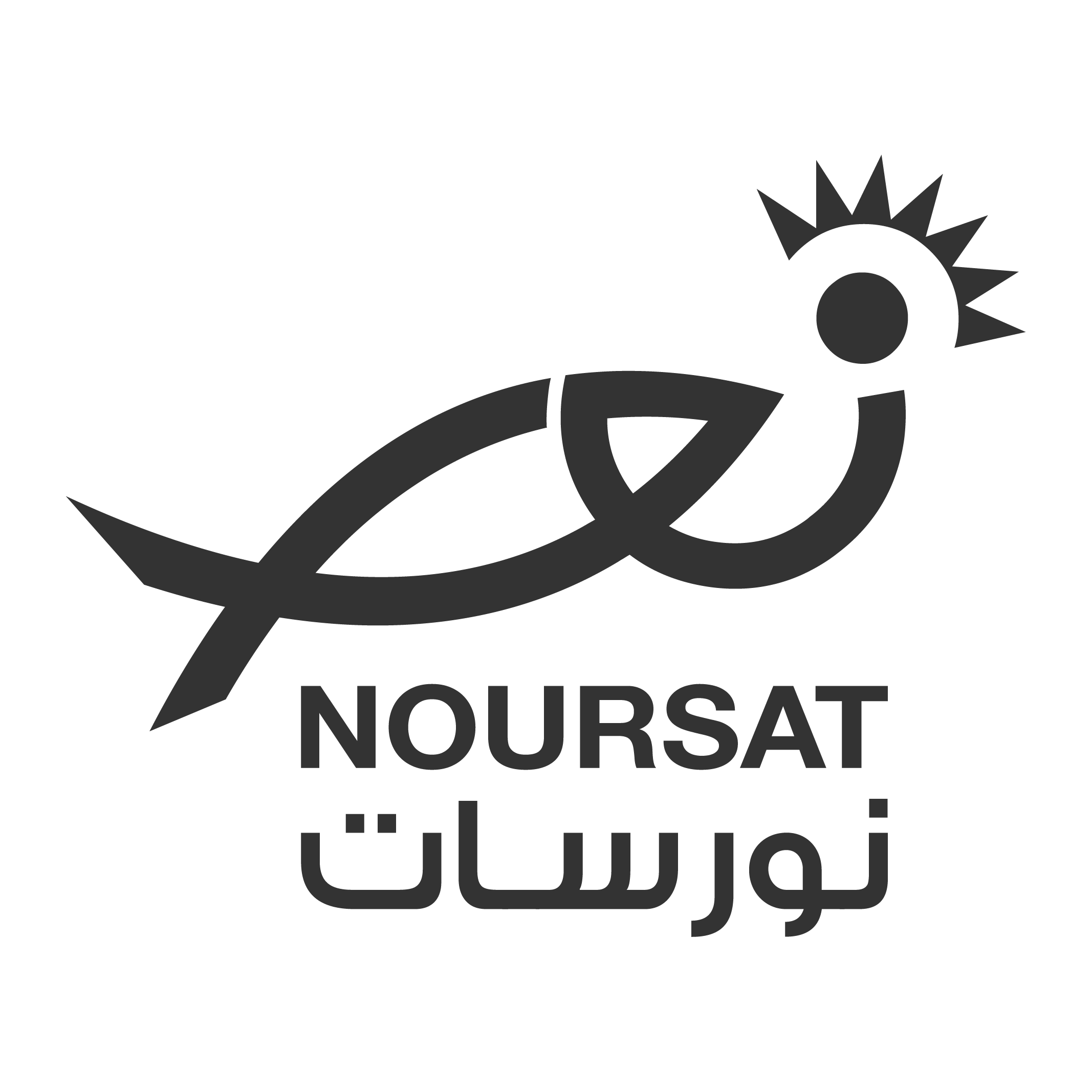ألقى واعظ القصر الرَّسوليّ الأب روبرتو بازوليني تأمّله الثّالث لزمن المجيء في قاعة بولس السّادس بالفاتيكان بحضور الأب الأقدس، تحت عنوان: “باب الصِّغَر”.
وفي تأمّله الأخير لهذا الزّمن، قال بازوليني بحسب “فاتيكان نيوز”: “لقد انطلقنا في مسيرة المجيء هذه تحت إرشاد الأنبياء وأصواتهم القادرة على أن تُشعل النّور وتنظِّم مسيرتنا. لقد عبرنا أوّلًا باب الدّهشة، لكي نتمكّن من الإعجاب ببذور الإنجيل الحاضرة في العالم وفي التّاريخ. ثمّ وقفنا أمام باب الثّقة، لكي نسير مجدّدًا نحو الآخرين بقلوب محترمة ومنفتحة. واليوم، في تأمّلنا الأخير، نريد أن نعبر الباب الأخير، وربّما الأهمّ في ضوء عيد الميلاد الّذي يدخلنا في سنة اليوبيل المقدّسة: باب الصِّغَر.
عندما نتصفّح الكتاب المقدّس، من العهد القديم إلى العهد الجديد، يتبيّن لنا بوضوح متزايد كيف أنّ الصّغر هو الخيط المشترك الّذي يمرّ عبر أحداث وإعلانات تاريخ الخلاص. للوهلة الأولى، يبدو أنّ هذا البُعد ينتمي إلى الضّعف البشريّ، وهو أمر غالبًا ما نحكم عليه بأنّه غير مهمّ أو غير مناسب. ومع ذلك، فإنّ الصّغر في عيني الله هو ثمين ومهمّ. نكتشف هذا، على سبيل المثال، في بعض قصص الدّعوة، مثل قصّة جدعون الّذي رأى نفسه غير ملائم أمام الدّعوة الّتي نالها من الرّبّ: “فالتفت إليه الرّبّ وقال: “انطلق بقوّتك هذه وخلّص إسرائيل من قبضة مدين، أفلم أرسلك؟ فقال له جدعون: “ناشدتك يا سيّدي. بماذا أخلّص إسرائيل؟ هذه عشيرتي أضعف عشيرة في منسَّى، وأنا الأصغر في بيت أبي”. هناك أيضًا دعوة صموئيل الّذي بعد أن تخيّل شاول ملكًا قويًّا وجبّارًا، عليه أن يغيّر نظرته ليتعرّف في داود الشّابّ على مختار الله: ” فأجاز يسّى سبعة بنيه أمام صموئيل، فقال صموئيل ليسّى: “لم يختر الرّبّ من هؤلاء”. ثمّ قال صموئيل ليسّى: “أهولاء جميع الفتيان؟ ” فقال له: “قد بقي الصّغير، وهو يرعى الغنم”. فقال صموئيل ليسّى: “أرسل فجئنا به، لأنّنا لا نجلس إلى الطّعام حتّى يأتي إلى ههنا”. فأرسل وأتى به، وكان أصهب جميل العينين وسيم المنظر. فقال الرّبّ: “قم فامسحه، لأنّ هذا هو”. كثيرة هي المقاطع الّتي يصرّ الله فيها على إظهار صِغرنا كمكان يمكن أن تتحقّق فيه اختياراته ومواعيده. بعض هذه النّصوص نقرأها في زمن المجيء، مثل نصّ النّبيّ ميخا: “وأنت يا بيت لحم أفراتة إنّك أصغر عشائر يهوذا ولكن منك يخرج لي من يكون متسلّطًا على إسرائيل وأصوله منذ القديم منذ أيّام الأزل.”
عندما نتعمّق أكثر في الكتاب المقدّس ونوجّه ذكاءنا الرّوحيّ نحو سرّ تجسّد الكلمة، نكتشف أنّ الصِّغَر ليس فقط صفة من صفاتنا، المتناغمة بشكل سرّيّ مع مخطّط الله، بل هو أيضًا طريقة يتجلّى فيها جوهر العليّ. فهو، في الواقع، يكشف عن نفسه كحضور خفيّ وغير مرئيّ: من الرّوح الّذي كان “يرف على وجه المياه” إلى “صوت النّسيم اللّطيف” الّذي تعرّف فيه إيليّا على حضور الله الحقيقيّ. إنَّ دلائل الصّغر هذه تصبح يقينًا في عيد ميلاد ابن الله الّذي يظهر في هشاشة طفل حديث الولادة، يتعرّف عليه الرّعاة ويعبده المجوس. كما يؤكّد القدّيس يوحنّا في مقدّمة إنجيله، إنّ حضور الله في جسدنا البشريّ هو “صغير” لدرجة أنّه يمكنه أن يمرّ بدون أن يلاحظه أحد، وبالتّالي لا يقبله إلّا الّذين يعرفون كيف يتعرّفون عليه.
لقد ترافقت كرازة يسوع على الدّوام بدعوات واضحة وعميقة لكي يرى معاصروه في الصّغر مفتاحًا أساسيًّا لفهم ملكوت الله وقبوله. فهو يشدّد على أنّ الّذين يعرفون كيف يجعلون أنفسهم صغارًا ومتواضعين وجاهزين فقط يمكنهم أن يدخلوا في انسجام مع سرّ الملكوت. لذلك فهذا الصّغر ليس قصورًا أو نقصًا، بل هو استعداد داخليّ يسمح للمرء بأن يتنبّه لحضور الله ويعاونه في مخطّط محبّته. وبالتّالي يدعونا يسوع لكي نتعرّف على ملكوت الله لا في المظاهر القويّة والملفتة للنّظر، وإنّما في القوّة الصّامتة والمتواضعة للبذرة الّتي تنبت وتنمو ببطء في الواقع اليوميّ. إنّه حضور وديع وغالبًا ما يكون خفيًّا يتطوّر تدريجيًّا ويتطلّب عيونًا قادرة على التّعجّب والاندهاش وقلبًا منفتحًا على الثّقة. إنّ قبول هذا البُعد يعني الاعتراف بأنّ الله يعمل بصبر، بدون استعجال الأمور، ويترك عمله يكتمل فينا في الاحترام الكامل لحرّيّتنا.
لتعميق هذا المصير من الصِّغَر الّذي نحن مدعوّون فيه لكي نختار ونتبنّى ربّما أكثر السّمات حساسيّة وحسمًا في تشابهنا مع الله، يمكننا أن نقرأ مجدّدًا بطريقة متأنّية ومتجدّدة المثل الشّهير في إنجيل متّى الفصل الخامس والعشرين. هذا التّعليم الّذي يدعو فيه يسوع التّلاميذ إلى التّأمّل حول الصّلة بين أعمالنا اليوميّة والحياة الأبديّة، والّذي لطالما تمَّ فهمه كتذكير كبير بموضوع محبّة القريب، هو عصب الإنجيل كلّه. ووفقًا للتّفسير الأكثر رسوخًا، فإنّ عودة يسوع كابن الإنسان- أيّ كديّان- في نهاية الأزمنة ستكون لحظة سيُحكم فيها أخيرًا على حياة كلّ شخص وفقًا لمعيار المحبّة الأخويّة. إلى يمين الرّاعي، سيذهب بسعادة كلّ من قد تحلّى بالشّفقة تجاه قريبه. أمّا إلى الشّمال فسيذهب الّذين أغلقوا حساسيّتهم تجاه القريب، ولم يقوموا باللّفتات الضّروريّة للمحبّة الأخويّة والرّحمة الإنسانيّة.
إنّ .تحليل الشّخصيّات في هذا المثل يكشف عن مفاجأة: يستخدم الإنجيليّ متّى مصطلح “ethnos” للإشارة إلى الشّعوب الوثنيّة، الغريبة عن تقليد إسرائيل. وهذا أمر مهمّ، لأنّ متّى يكتب لجماعة مسيحيّة من أصل يهوديّ عاشت في منطقة متاخمة للشّعوب الوثنيّة، غريبة عن إيمان إسرائيل وعن الإيمان بإنجيل المسيح. في هذه الجماعة، على الأرجح، طُرحت بعض الأسئلة: والشّعوب الأخرى الّتي لم تتعرّف بعد على سرّ المسيح ولم تقبله، كيف ستستطيع أن تنال الخلاص في اليوم الأخير؟ انطلاقًا من هذا السّؤال، نفهم كيف أنّ الهدف من المثل ليس الكشف عن كيفيّة حصول الدّينونة العامّة، بل الإعلان عن كيفيّة حصول جميع الشّعوب الّتي لم تعرف الإنجيل بعد على الدّينونة والخلاص على قدم المساواة من خلال معيار موضوعيّ ومشترك. لذلك لا يجب أن يُقرأ المثل على أنّه تعليم يوضح للمسيحيّين كيف يخلصون أو يهلكون. لأنّه على ابن الله أن يعرف هذا مسبقًا: من خلال محبّة أو عدم محبّة قريبنا كحبّنا لأنفسنا، حتّى عندما يكون الآخر عدوّنا. يريد هذا المثل إذًا أن يذكّر المسيحيّين بأنّه حتّى الّذين لم يسمعوا كلمة الإنجيل يمكنهم أن يخلصوا، ببساطة عن طريق الاهتمام بإخوتهم “الصّغار” ومحبّتهم.
إذا كان من المشروع أن نرجو في أن يتمكّن جميع النّاس في يوم من الأيّام من دخول الملكوت من خلال المحبّة الّتي تمارس تجاه “إخوة الرّبّ الصّغار”، فإنّ مسؤوليّة المسيحيّين كبيرة- لا بل جسيمة. لأنّ مهمّة للكنيسة الأساسيّة ليست فقط فعل الخير للآخرين، بل تمكين الآخرين من القيام بذلك أيضًا، معبِّرين هكذا عن أفضل ما في إنسانيّتهم. كيف يمكن لجماعة أبناء الله أن تؤدّي هذه المهمّة بذكاء؟ أوّلًا من خلال جعل الصِّغر معيارًا لتشببهها وأمانتها لربّها ومعلّمها. وهذا هو المعنى الأوّل للمثل الّذي لا ينبغي أن ننساه أبدًا أو أن نحوّله إلى لغز: قبل أن نصنع الخير، من الجيّد والضّروريّ أن نتذكّر أن نجعل من أنفسنا صغارًا. وبالتّالي فإنّ تلاميذ المسيح ليسوا مدعوّين لكي يخافوا من اليوم الأخير، وإنّما لكي يستغلّوا الزّمن الحاضر لكي يجعلوا من أنفسهم صغارًا لكي يكونوا موضع عناية القريب ومحبّته. إنَّ الله لا يهمّه فقط أن يعرف أبناؤه كيف يحبّون، وإنّما أن يكونوا أيضًا في سلام مع الفنّ الأصعب بالسّماح للآخرين بأنّ يحبّونهم.
عادة ما نعتقد أنّ يسوع طلب منّا في الإنجيل أن نكون صالحين وأسخياء مع الآخرين. لكن البصيرة الإنجيليّة للقدّيس فرنسيس الأسيزيّ تذهب أبعد من ذلك، وتذكّرنا بأن هناك أمرًا أكثر أهمّيّة يجب أن نفعله، ويتعلّق بأسلوبنا في الحياة: أن نمنح الآخرين الفرصة لكي يكونوا صالحين وأسخياء معنا. إنّه أسلوب محبّة أكثر دقّة وعمقًا، نتنازل فيه عن طيب خاطر عن مركز الصّدارة للآخر، لكي نسمح لإنسانيّته بأن تتجلّى بأفضل طريقة ممكنة. أن نجعل أنفسنا صغارًا ونتعلّم أن نتحرّر من الكثير من الزّخارف غير الضّروريّة هو الدّرب الرّئيسيّة لكي نشفي الصّدمة العميقة للخوف والخجل الّتي تطبع بشريّّتنا. ولكن غالبًا ما نحاول أن نُخفي هذا الصّغر من خلال القيام بأدوار وأداء العديد من الأعمال لكي نشعر بأنّنا أعظم وأكثر أهمّيّة. إلّا أنّ الإنجيل يقدّم لنا علاجًا أفضل: أن نتوقّف عن الاختباء ونسمح للآخرين بأن يلتقوا بضعفنا ويقبلوه.
لقد أشار البابا فرنسيس في مقدّمة الرّسالة العامّة “Fratelli tutti” إلى رحلة القدّيس فرنسيس الشّهيرة إلى مصر في زمن الحروب الصّليبيّة للقاء السّلطان الملك الكامل الّذي أراد أن يحمل إليه إعلان إنجيل المسيح واقتراحه. في الواقع، لم تسر الأمور في ذلك اللّقاء كما كان فقير أسيزي يرجو. إذ بقي السّلطان مخلصًا لدينه، ولكنّه استقبل فرنسيس الوديع بمودّة كبيرة ومحبّة ملموسة. هذه “المهمّة”، الّتي لم تتحقّق وفقًا لمنطق النّجاح البشريّ، لم تكن عقيمة وفقًا لمنطق الإنجيل. صحيح أنّ القدّيس فرنسيس لم يغيّر رأي السّلطان، ولكنّه قدّم نفسه له فقيرًا ومريضًا، وأتاح له الفرصة لكي يُظهر اهتمامه به. إنّ هذه الطّريقة في الاقتراب من الآخر- بوداعة متجرّدة- هي فعل بشارة حقيقيّ لأنّها تُظهر أسلوبًا إنسانيًّا مولّدًا للغاية: وهو أن نضع الآخر في حالة يكون فيها أكثر أمانة لنفسه، مجسدًا بذلك تصرفات محبة أخوية. وباتِّباع إرشادات يسوع، لكي نعلن الملكوت يكفي أن نقترب من الآخرين ببساطة، سواء في الأساليب أو الوسائل. من المهم أن نعلن سلام الرب بحرية، وأن نسمح بشكل خاص للآخرين بأن يقبلوننا ويرعوننا ويعتنون بنا في الاحتياجات الأساسية لإنسانيتنا. وعندما يحدث هذا، يمكننا أن نعلن اقتراب الملكوت بدون أن نضع الشخص الذي يقبلنا تحت ضغط أو في عجلة للقيام بشيء أكثر مما قد قدمه بسخاء.
ولكن المفاجآت الموجودة في مثل الراعي الذي يفصل – بدون أن يضطر إلى الحكم – الخراف عن الجداء لم تنتهِ. وبينما يظهر بوضوح كبير ما سيكون الفرق بين الأبرار والآخرين – أنهم اعتنوا أو لم يعتنوا بإخوة يسوع الصغار – لا يبدو واضحًا على الفور لماذا لا يبدو أن هناك فرقًا بين هاتين الفئتين في طريقة رد فعلهم على كلام ابن الإنسان الجالس على عرش مجده. وما يلفت النظر هو أن رد فعل الأشرار يشبه تمامًا رد فعل الأبرار، بعد أن نالوا مديح ملك المجد على سلوكهم في الحياة: “يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشان فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فجئنا إليك؟”. يبدو أن الأبرار قد تفاجؤوا بالقدر عينه عندما تلقوا خبر أعمال المحبة التي قاموا بها تجاه الصغار. في الواقع، إن الإصرار الثلاثي للظرف “متى” يجعلهم يبدون أكثر دهشة – أو ربما غير مدركين – للأوقات التي ربما كانت لديهم فيها الفرصة لكي يمارسوا المحبة الضرورية للخلاص. وبالتالي أن يكون الأشرار مضطربين ومرتبكين يبدو لنا معقولاً جداً. لكن أن يكون الصالحون كذلك أيضاً لا يمكن إلا أن يدهشنا ويثير تساؤلاتنا: لماذا، في نهاية الزمان، سيكون الجميع غير مدركين لما فعلوه أو أغفلوا عنه من خير؟
بالطبع، إن الوعي الكافي بما نحن عليه وما نفعله يُبنى مع مرور الزمن، وعندما نبلغه، نتفاجأ على الدوام. هناك أوقات نخدع فيها أنفسنا بأننا صالحون ونفعل الخير، ولكن مع مرور الوقت ندرك أن الكثير من هذا الخير كان مجرد وسيلة لتأكيد أنفسنا على الآخرين، والتباهي بالسخاء. وبالطبع يلاحظ الآخرون ذلك. والعكس صحيح، عندما نقضي وقتًا طويلًا ونحن نشعر بالخطأ والنقص، وأننا مجبرون على التعايش يوميًّا مع شعور قوي بالنقص. ومع ذلك، لا يرانا الآخرون بهذه الطريقة على الإطلاق، بل على العكس، هم يسعون إلى إقامة علاقة معنا لأنهم يشعرون بالقبول والتقدير من قِبَلنا: “فلا تدينوا أحدا قبل الأوان، قبل أن يأتي الرب، فهو الذي ينير خفايا الظلمات ويكشف عن نيات القلوب، وعندئذ ينال كل واحد من الله ما يعود عليه من الثناء”.
إنَّ الذي يكتشف أبوة الله لا يشعر بالحاجة إلى أن يحكم على نفسه أو على الآخرين. فالمسألة ليست مسألة أن ننزلق إلى اللامبالاة أو عدم الاكتراث، وإنما أن نقبل أن كل واقع وكل شخص هو ضمن صيرورة مستمرة. وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على ذواتنا، نحن الذين غالبًا ما نكافح لقبول واقعنا والتصالح مع أنفسنا ومع ما نحن عليه وما تمكنا من أن نصبح عليه: “لا تدينوا فلا تدانوا. لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم. أعفوا يُعفَ عنكم. أعطوا تعطوا: ستعطون في أحضانكم كيلا حسنا مركوما مهزهزًا طافحًا، لأنه يكال لكم بما تكيلون”. إن كلمات يسوع في مثل متى تسير في هذا الاتجاه بالضبط، وتقدم عنصرًا آخر. إن ديان التاريخ لا يريدنا أن نحكم على أي شيء قبل أوانه، ولكنه يريدنا في الوقت نفسه أن نشحذ قدرتنا على تقييم الأمور بحكمة وشفقة، لكي نتجنب أن نكون في النهاية أقسى القضاة على أنفسنا. إذا لم تكن مهمّتنا أن نحكم على أنفسنا، يمكننا أن نركز على ما يهم حقًا: أن نسعى لأن نصبح حقيقيين بشكل أكبر، وأن نسمح للحب بأن يتحقق فينا وفي الآخرين بأكبر قدر من حرية القلب. هذه، هي باختصار، الرسالة المركزية في مثل متى وإنجيل المسيح بأكمله: أن نعيش الدعوة إلى المحبة الأخوية بحرية ومجانيّة. في الواقع، هناك مناسبات عديدة حثّ فيها يسوع التلاميذ على أن يعملوا الخير دون أن يقلقوا على أنفسهم، “غير راجين عوضًا”، لكي يكونوا هكذا “أبناء العلي”.
تعلّمنا العلوم الإنسانية أنه لكي ننمي الثقة بأنفسنا، من الضروري أن نشعر بالتقدير منذ الطفولة. ومع ذلك، وكما يحذر يسوع، فإن تلقي عبارات الامتنان المستمرة يمكنها أن تصبح أمرًا محفوفًا بالمخاطر إذا تم ذلك بشكل مفرط. إن التصرف مع الانتظار المستمر للتقدير يحصر علاقاتنا بالأشخاص القادرين على أن يبادلوننا. هذا الموقف يخلق ديناميكية من التبادل المشروط، ويمنعنا من الانفتاح على علاقات حقيقية وحرة وبدون مصلحة. من أجل تجنب هذه الديناميكية الانتهازية، لا يوجد طريق آخر غير طريق المجانية الكاملة. لكنَّ الأمر لا يتعلق فقط بإفراغ خزان التوقعات، وإنما أيضًا بامتلاك الشجاعة للتخلص من كل تلك الأشياء التي ما زلنا نقوم بها بدافع الذنب أو الواجب، بدون حرية كاملة. وستكون المفاجأة الكبرى في نهاية الزمان عندما نكتشف أن الله لم يكن لديه انتظارات منا سوى الرغبة العظيمة في أن يرانا نصبح مثله في المحبة. في ذلك اليوم، لن يكون المهم حقًا مقدار الأعمال الصالحة أو السيئة التي قمنا بها، وإنما ما إذا كنا قد تمكنا من خلالها من قبول أنفسنا وأن نصبح ذواتنا بشكل كامل.
إنَّ الصِغَر هو سمة صورة الله التي ننجذب إليها أكثر من غيرها وننفر منها أكثر من غيرها. فمن ناحية، هو يخلق فينا نوعًا من عدم الارتياح لأنه يكشف لنا الخطيئة والتجربة المستمرة لرفع أنفسنا فوق ذواتنا، مما يضعف صورتنا. ومن جهة أخرى، هو يسحرنا لأنه يسمح لنا بأن نتصالح مع إنسانيتنا الصغيرة والعظيمة في الوقت عينه. وبمناسبة عيد الميلاد هذا، الذي يدخلنا في فسحة اليوبيل المقدّس، ربما يكون الصِغر بالتحديد النبوءة العظيمة التي قد نختار أن نجسدها لكي نشارك العالم رجاء الإنجيل. وكما كتب قداسة البابا في مرسوم إعلان اليوبيل: “إزاء عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل، لا أحد يعرف “ما الذي سيحمله الغد معه”، نحن جميعًا تهزُّنا “مشاعر متعارضة أحيانًا”: الثقة والخوف، السكينة والإحباط، اليقين والشك”. وبالتالي فالكنيسة تشعر بمسؤولية المرور عبر باب الخلاص الوحيد الذي هو المسيح، الذي به لدينا مرساة رجاء، وندرك أننا بنعمته يمكننا أن نتغلب على الخطيئة والخوف والموت. ولكي نكون شهودًا صادقين لإمكانية الحياة الجديدة هذه، لا نحتاج لأن ننتظر لكي نصبح أفضل أو مختلفين عما نحن عليه. لا بل، وبعد ألفي سنة من التاريخ المسيحي العجيب، يمكن لتلاميذ الرب القائم من الموت أن يمارسوا حرية أن يقدّموا أنفسهم للعالم بخوف أقل وبدون خجل من أن يكونوا “أصغر” مما كانوا عليه، وربما حتى مما كانوا يعتقدون أنه ينبغي أن يكونوا عليه لكي يشهدوا لإنجيل الله.
إن عبور باب اليوبيل المقدس بصدق كبير، بدون أن نقلق من أن نُضطرَّ إلى إظهار صّورة مختلفة عن تلك التي استطاعت الكنيسة أن تطورها على مر القرون، يمكنه أن يكون بالفعل رجاءً عظيمًا. أولاً بالنسبة لنا نحن المؤمنين، الذين ننسى بسهولة أننا خدام إله متواضع وفقير. ثم بالنسبة للعالم، الذي غالبًا ما نعتبره معاديًا أو غير مبالٍ برجائنا، بينما هو في الواقع ينتظر فقط أن يتعرف على وجه الآب الرحيم في جسد أبنائه الهش وإنما المحبوب على الدوام. نحن نعرف هذا الأمر جيدًا. كل ما علينا أن نؤمن به ونردده بفخر متواضع: في المسيح يسوع “لنا جميعا سبيلا إلى الآب في روح واحد”، ونحن “شركاء في الميراث والجسد والوعد في المسيح يسوع، ويعود ذلك إلى البشارة”.